اقتباسات من كتاب «أقصى ما يمكن – يوميات 3» لمصطفى ذكري
إصدار الكتب خان – 2018
***

«وأنا أكمل عملًا، وقفت ثلاثة أعمال أخرى غير مكتملة حاجزًا أمام العمل الذي تقدمت في كتابته إلى ما قبل النهاية بقليل، هناك عار أشعر به في عدم قدرتي على إنهاء عمل، عار يغذيه الوقت، ومن النذالة أن لا أعطي فرصة للوقت، لا أقصد الكسل أو الفشل، فهما صديقان على طول الطريق، ولي معهما ود، أما الوقت فهو من يريد دائمًا الفرصة ربما ليربط بين التأجيل والقيمة أو ربما ليزرع بيني وبين الصديقين كراهية».
***
«على الحاجز الخشبي دفتر كبير مفتوح على مصراعيه، وقلم رصاص مربوط من أعلاه بدوبارة نهايتها مثبتة بمسمار خفي أسفل الحاجز الخشبي، كتبت اسمي الثلاثي، ورقم البطاقة الشخصية، وعنوان البيت، والهدف من الزيارة، الاستعارة أم القراءة؟ يقع اختياري دائمًا على القراءة، رغم أنني في نهاية اليوم آخذ كتابًا للاستعارة، الهدف من الزيارة، كأنها جملة لتعرية الزائر، وفضح نواياه، وماذا لو لم يكن هناك هدف من الزيارة، أقضي الساعات في المكتبة تحت وطأة السؤال، ليس لأنني لا أريد القراءة أو الاستعارة بل لأن القراءة أو الاستعارة تأتي عَرَضًا لهروب غير ذي معنى يستأنس بجوار، بحيث لو لزم الأمر أحتمي بهدف الزيارة».
***
«رأيت بالصدفة لقطات من فيلم تسجيلي عن الكاتب المصري الراحل ألبير قصيري، الفيلم قبل موته بثلاث سنوات، كان عمره في زمن الفيلم واحد وتسعين عامًا، اللقطات بسيطة، ألبير يعبر شارعًا للوصول إلى حديقة عامة، يجلس على كرسي، يعود إلى غرفته المتواضعة في بنسيون، المؤثر في الفيلم طغيان الزمن على جسم ألبير، فهو ضئيل ومنكمش، وكأن انكماش الجسم هي فاتورة الواحد وتسعين عامًا، وكأن الزمن لن يحفظ سمعته إلا بهذا الطغيان، في المقابل يستسلم ألبير، ويبدو وهو يخطو على أرض الشارع، وكأنه يدوس على لوح من الزجاج عُرضة للكسر، وحتى إذا كانت الأرض من زجاج، فوزن جسمه الذي لا يتعدى الخمسة وأربعين كيلوجرامًا لا قِبَل لها بكسر الزجاج، فكرت أنه عند عمر معين أحيانًا تتم المساومة المهينة بين عجوز وزمن، لك الطغيان ولي الاستسلام».
***
«كنت قد عاهدت نفسي أمام الكتابة بعربون الوقت المفتوح، ليس أقل من زمن أبدي لكتابة جملة، حجة البليد، ربط ذيل الكتابة بذيل الزمن، شد وأنا أشد، حبل مشدود بين نافذتين متقابلتين، مهرج نيتشه يخرج من نافذة، وفي يديه عارضة التوازن، يخطو على الحبل، زرادشت في الأسفل، الناس في الساحة معلَّقة عيونهم بالمهرج، ما أن يصل المهرج إلى منتصف الحبل إلا وتنفتح النافذة التي خرج منها مرة ثانية، مهرج ثان يتقدم على الحبل. الأفضل مشهديًا وسينمائيًا أن يخرج المهرج الثاني من النافذة المقابلة، لكن نقول إيه لنيتشه؟ ميزانسين ملكلك، يقول: تنفتح النافذة مرة ثانية، هو كان المهرج الأول قفلها قبل ما يمشي على الحبل؟ يقفز المهرج الثاني على المهرج الأول، يقع المهرج الأول في الساحة، لم يقل لنا نيتشه هل وصل المهرج الثاني إلى النافذة المقابلة، زرادشت في الليل، وهو يدفن المهرج الأول، يجد أمامه المهرج الثاني، كان المشهد السينمائي مطية للمعنى، نخاسة، ركوبة، مداسًا. الله يسامحك يا عم نيتشه».
***
«تحمَّر وجوه أبطال دوستويفسكي وتصفرُّ، ترتعش شفاههم، تخفق دقات قلوبهم، يجاهدون توالي الانفعالات على سحناتهم، تتضخم أرواحهم، يتسوَّلون الدراما على عتبات البيوت والغرف الضيقة والممرات والبارات والأقبية، مراهقون في العشرينيات يحملون فلسفات سيئة الصياغة، يقرأون كثيرًا بوشكين وجوجول، يراهنون على خجل القارئ أمام صدق أفعالهم في القتل والحب والصداقة».
***
«إنني أستطيع لوم نفسي إلى ما لا نهاية، بحيث يصعب على أحد غيري تسديد ضربة إضافية، ويرتكز اللوم في مجمله على بضعة أمور كنت قد حلمت بها صغيرًا، وعوَّلت في حال تحققها على سعادة تكفي لدفع طاقات الملل، وحدث أن ما حلمت به تحقق، لكن بانطفاء وخمود وبطء».
***
«حلمت بأنني تركت مهنة الكتابة، وفتحت محلًا لبيع الأدوات المكتبية. وكان المحل على مدينة ساحلية. تصعد سلالم قليلة من رمال البحر، فتجد نفسك أمام المحل الصغير على الطريق. أغلب الزبائن من الشاطئ. يتجهون إلى ركن في المحل لشراء جريدة أو مجلة. وهذا الركن هو الذي يسد رمقي. أما الأدوات المكتبية فهي إثبات شخصي على تغيير المسار، ويخرج فقط عند الضرورة».
***
«كانت الدراسة بالنسبة لي، وبمراحلها جميعًا، ألمًا لا شفاء منه، نصلًا مغروسًا في الجنب، يلف على محوره من وقت لآخر، وحتى بعد انعتاقي النهائي من الدراسة الجامعية، منذ أكثر من عشرين سنة، ما زال الألم شبه الجسدي، شبه النفسي، يعود مختلطًا في الذاكرة بما يشبه تقارير إدانة عن مشاهد تقصير دراسي لا أتذكرها تفصيلًا، لكنني لا أنكرها جملة، فيضاف على الذاكرة عبء الشعور بالذنب، وأمر ملح أتى باستعادة مشاهد التقصير الدراسي بكل تفاصيلها، وكأنها حدثت بالأمس. لم يكن تقصيري الدراسي يرجع إلى تعال ذهني على المواد الدراسية، التي لا أستطيع أيضًا الدفاع عن علو شأنها، بل يرجع إلى خوف معتم من بذل مجهود ذهني يُقابَل في النهاية بنتائج عادية، وإذا كانت تلك النتائج العادية المسالمة غير المحسوسة التي تنقلني من امتحان إلى آخر، ومن سنة إلى أخرى، ومن مرحلة دراسية إلى أخرى، تتم تحت غطاء الحد الأدنى من المجهود الذهني، فقد كان تأجيل ذلك الجهد اللازم، مخدرًا مستدامًا، وخزينًا للطاقة لا ينضب».
***
«أستاذ مادة الدراما في المعهد العالي للسينما قال لنا يومًا: إذا استطاع أحدكم اختيار أقوى نقطة درامية نستطيع منها الدخول للفيلم الملحمي (الطيب والشرس والقبيح) للكتابة عنه، له مني 100 جنيه. بعد أسبوع كانت معظم الاختيارات لا تخرج عن الأبطال الثلاثة في الفيلم. كلينت إستوود، وإيلي والاش، ولي فان كليف. كان اختياري بعيدًا. اخترت شخصية بيل كارسون، وهو شخصية ثانوية في الفيلم، لكنها شخصية تُمثل الغياب/الحضور، وتحرك الحدث الدرامي عن بعد. بيل كارسون يظهر مرة واحدة أثناء موته، وهو الحامل لسر النقود الذهبية. أخذت 100 جنيه وسط امتعاض الزملاء الذين اقترحوا احتفالًا وتبديدًا للمال في الليل. قلت لهم: مَن مثلي الأعلى في فيلم (الطيب والشرس والقبيح؟) صمتوا جميعًا. قلت ضاحكًا: توكو. لو كان توكو مكاني لما صرف ماله على مقاطيع سينما ميديوكر بحجة الزمالة».

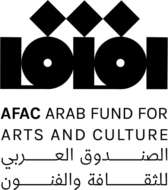
One Reply to “أقصى ما يمكن – مصطفى ذكري – اقتباسات”
يا إلهي